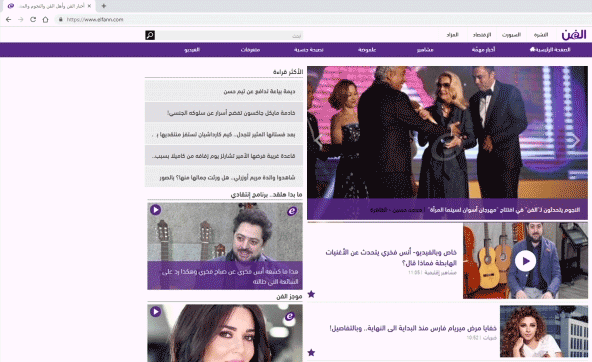برحيل زياد الرحباني، يطوي لبنان آخر فصول زمن العباقرة، الذين سبقوا الزمن والمستقبل، بالنغمة والكلمة اللتين تحولتا إلى رؤية وفكر وتوجه تصنع مصير أوطان.
برحيل زياد لا يغيب فنان فحسب، بل تغيب ظاهرة بحجم وطن، يغيب العقل الموسيقي، والفكر النادر الذي وقف على مسافة واحدة من الناس والحق، ومن الألم والأمل.
نودّع فناناً لم يلبس يوماً قناعاً، ولم يدّعِ التفرّد، لأنه ببساطة، كان متفرّدًا بالفطرة، ومتمردًا بموسيقاه التي صنعت هوية للبنان، ووضعته في مصاف البلدان المعروفة بمكتباتها الموسيقية.
منذ أن خطّ أولى كلماته، ودندن أولى نوتاته الموسيقية على سلم النجاح، لم يكن زياد ابن فيروز وعاصي فقط، بل كان ابن هذا الوطن المعذَّب، ابن الشارع المكتظ بالأسئلة، ابن الفقر المغلف بالكرامة، ابن الحرب التي علّمته أن الموسيقى قد تكون صرخة لا طلقة، ابن الصدق حين يصبح الصدق موقفاً مكلفاً.
لم يكن فن زياد الرحباني مجرد فن، بل ثورة ناعمة، وأحيانا متمردة على السائد والمعلّب.
لم تكن موسيقاه ترفاً جماليًا، بل عمقاً إنسانيًا يتسلل إلى الروح، جرأته في كسر قواعد التلحين وفي اللعب على "الربع نوتة"، لم تكن عبثًا فنيًا، بل إعادة صياغة للوجدان العربي، بلغة تُشبهه وتُشبهنا.
زياد لم يؤلف موسيقى فحسب، بل بنى مدرسة من الصعب تقليدها، لأن أساسها كان الصدق، وكان الصمت فيها أبلغ من الكثير من الضجيج الفني الذي ملأ العالم العربي لاحقًا، هو وحده من صاغ النغمة كأنها تنهيدة من صدر شعب يئنّ ولا يتكلّم، هذه المدرسة يجب أن تتحول إلى نهج يُدرس في المدارس والجامعات نظرًا إلى فرادته.
لم تُرنَّم ترانيمه في الكناس لأنها جميلة فقط، بل لأنها حقيقية ليتورجية، انبثقت من روح صادقة، تعرف الله في بساطة الناس، وتُدرك الإيمان كممارسة للحب والعدل، وتنشدها اليوم ملائكة السماء، مرحبة بروحه الصادقة المحبة لله، على عكس ما اتهم يومًا بالإلحاد.
أما كتابه "الله صديقي"، فكان أكثر من عنوان، كان لحظة تأمل حميمة، فيها من الروحانية أكثر من ما في مئات الخطب، زياد لم يفصل يوماً بين الإيمان والعيش، بين الفن والسياسة، بين الحلم والوجع.
أذكره في لقاء تلفزيوني، يوم منعتنا المنتجة المنفذة من الإقتراب منه، وحين لاحظ وجودي اقترب مني، حيّاني، وأطربني بعسل الكلام. لم يكن زياد نجمًا، كان إنسانًا ببساطة، بصدق، بتواضع نادر.
فيروز.. آه يا فيروز. آهاتك اليوم وغدًا وبعد غد توازي الأم الحزينة، لم تحب أحدًا كما أحبّت زياد، لم تفتخر بأحد كما افتخرت به، كان ظلّها، مرآتها الحقيقية، امتداد صوتها حين تحرّر من المثاليات ليغني الحياة كما هي: بخدوشها، بجمالها وبمرارتها.
مع الأخوين رحباني، غنّت فيروز الحلم والمثاليات، ومع زياد، غنّت الوجع، وأصبحت معه أكثر من صوت سماوي، صارت صوتًا بشريًا يتألم ويضحك ويبكي ويعشق.
في وداع زياد العبقري، أناشد وزير الثقافة في لبنان غسان سلامة، بأن يُخلَّد اسم زياد، بجائزة سنوية وطنية تكرّم الإبداع الذي لا يساوم، وتمنح اسمه للذين مثله، تجرأوا على الحلم، وغنّوا للحقيقة.
رحل زياد، لكن صوته لن يسكت، سيبقى في أسماعنا هناك في آخر شارع الحمرا، الشارع الذي عشقه ومات فيه محمولًا على أكف اليسار والخصوم، وبوحدة حال وهو يقول: "أنا مش كافر… بس الجوع كافر، والذل كافر، والناس اللي ساكته عالحق كفّار".
برحيل زياد الرحباني، تسقط الأقلام وتصمت الألسنة، أمام عظمة إبداعك الذي لم يتكرر ولن يتكرر.