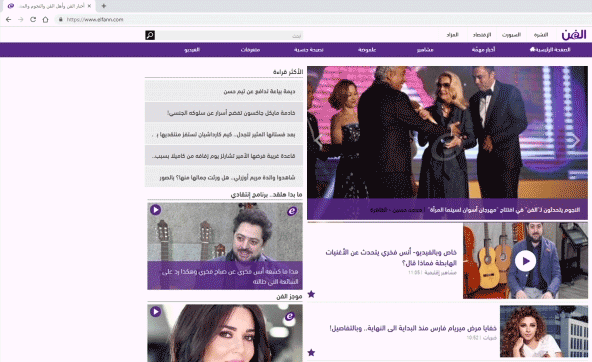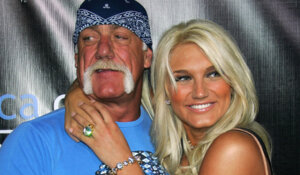وجيه نحله، الثمانيني المبدع، الحامل هموم الفن والوطن والحياة، رحل اليوم عن عمر ناهز الـ 85 عاماً وهو ما زال يمارس الرسم بحب وشغف وصدق، ويعمل في محترفه مدة 18 ساعة في اليوم.
هذا الفنان التشكيلي الذي انطلق من السفح الى القمة، ومن الكوخ الى القصر، ومن العتمة الى الضوء، ومن بيروت الى مختلف عواصم العالم ومدنه ومتاحفه، حاملاً الى الغرب ألوان الشرق، والى الشرق ما غاب عنه من ألوان الغرب، هذا الفنان المثير للجدل، الذي يواجه النجاح والشهرة بتواضع الدراويش، يعرف جيداً ان المعرفة لا حدود لها، ومهما عرفنا نظل نبحث ونجّرب، ولذلك فهو دائم البحث والتجريب. وعلى مدى 60 سنة، رسم آلاف اللوحات التي تنتمي الى مدارس ومذاهب وانواع تشكيلية عديدة، حتى صارت لوحته الخاصة تحمل البُعد العالمي والكثير من الدلالات والايحاءات والجمالية.
طوّر رسم العنصر التخطيطي، حرّكه مستعملاً فرشاة عريضة بدل ما كان يُستعمل من أقلام مسننه، ضغط الفرشاة على القماش في مطلع الحرف وراح يخفف من ضغطه وصولاً الى تلاشي الحركة واللون محدثاً تجسيداً بات بعد ذلك يضم حروفاً الى بعضها، خالقاً حركات هي أقرب الى أصوات اوبراليّة في سديم مضيء، وكررّ ذلك في معظم ما رسم من بشر وشجر وحجر، جاعلاً للخط ومنه ظلاً وتلك مأثرته المهمة.
اذا أعدنا النهر الى النقطة الاولى والحرف الى لوحة وجيه نحله نجد المنطلقات واحدة، فوجيه نحله ليس غامضاً كالسوريالي ولا قلقاً كالتعبيري ولا مبتهجاً بالضوء كالانطباعي، هو الذي روضّ الخط حتى أرقصه وركبّ فيه أجنحة حتى طيّره. لوحاته سرب كلمات استحالت طيوراً تبحث عن شمس في خريف العمر ... في شتاءاته القاسية.
ولد نحلة عام 1932، وبدأ يرصد خطوط الرسم الأولى في لوحات نسخت عن بطاقات سياحية. كانت تلك هواية والده المولع بالرسم بالبودرة والزيت. «كنت في الخامسة حيت صرت أخربش على لوحات أبي وأتلقى على تشويهي لها شيئاً من العقاب». نال جائزته الأولى في الرسم عام 1940، حين شارك في مخيم لـ«كشافة الجراح». «كان المخيم في بكفيا. أذكر أنني كنت أصغر أترابي. وزعوا علينا أوراقاً وألواناً وقالوا ارسموا عليها من وحي المخيم؛ بعد ثلاثة أشهر وصلت إلى البيت نسخة من مجلة «بيروت المساء» قرأتها أمي وشاهدت صورتي تحت عنوان: الكشاف الصغير وجيه نحلة يفوز بالجائزة الأولى. وكانت مقدمة لوسام علق على صدري من الرئيس رياض الصلح».
لاحقاً، صار يراقب على طريقه إلى المدرسة في محلة حوض الولاية، جاره التشكيلي الانطباعي العائد لتوه من إيطاليا مصطفى فروخ. ناداه هذا الأخير يوماً، وطلب منه أن يشتري له علبتي تبغ. يومها سأله فروخ عن سر مراقبته له، فأسرّ له ابن العاشرة باهتمامه بالرسم. «طلب مني أن أريه رسومي، فهرعت إلى البيت، وأحضرتها. سألني: «هذا شغلك؟ قل لأبيك أن يزورني». قال لوالدي: «ابنك موهوب، أنا سأهتم به خلال العطل المدرسية». وهكذا كان». بين جولات الرسم في الطبيعة مع أستاذه، ومحترف الخط العربي مع الشيخ محمد الهاونجي، توطّدت علاقة وجيه بالرسم أكثر فأكثر. عام 1950 انتدب مصطفى فروخ بعض لوحات تلميذه لتشارك في معارض متفرقة، وبعد عامين شارك في معرض الأونيسكو الكبير. «في تلك الأيام كنت مأخوذاً بمشاهدات إنسانية مثل العتال وبائعة الصعتر وغيرهما». في الجامعة اللبنانية، بدأ دراسة الطوبوغرافيا، وحصد المرتبة الأولى بين «الأعمال التصوّرية لبيروت عام 2000». كتبت الصحف عن الموهبة الصاعدة في ذلك الحين، ونال منحة للتخصص في الولايات المتحدة الأميركية، لكنّ والده عارض سفره بعدما اتسعت العائلة إلى 12 ولداً، وبات على وجيه المساعدة في إعالتها.
في مطار بيروت، اشتغل طوبوغرافياً ورساماً هندسياً، منذ عام 1956. في تلك الفترة، بدأت عودة الدفعة الثانية من الرسامين الفنانين من الخارج، وبدأت المدارس تتخلص من الانطباعية لتنحو باتجاه التجريدية. نصحه مصطفى فروخ وهو على فراش المرض بأن يبحث عن كنزه في العالم العربي والإسلامي. بعد جولة للتأمل في الدول الإسلامية، لفت انتباهه الحرف العربي المكتوب. «أخذت أتعلّق بالخط، وخصوصاً بعد زيارتي متحف الباب العالي في إسطنبول. أمضيت هناك ثلاثة أشهر للتمحيص بالخط العربي، ولا سيما المخطوطات الإسلامية بخط عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. قررت بعدها إدخال الخط في اللون، والرسم استناداً إلى الحرف العربي، وتخليت عن رسم المناظر الطبيعيّة».
في تلك الفترة، زودته شقيقته بعلبة فيها مادة بوليستير، مع سائل. خلط هذه المادة مع مواد أخرى، وبدأ يرسم الحرف النافر. ساعدته معلوماته الهندسية، في توزيع الآيات بمسافات متساوية. «بيعت إحدى اللوحات بـ 170 ألف فرنك فرنسي في ذلك الحين. كانت آية الكرسي التي لم تكتب حتى اليوم كما كتبتها بحرف مقروء كأنّه منحوتة».
منذ منتصف الستينيات، نحا باتجاه دراسات الحروف والتراث الشرقي، وبدأ يشتغل لوحات للقصور الملكية في عدد من الدول العربية. وأمام هذا الطلب على لوحاته، اضطر إلى الاستقالة من الوظيفة والتفرغ للفن. من الحروفية إلى الإسلاميات، إلى رسم جداريات... كلّها تجارب جعلت من وجيه نحلة رساماً ذائع الصيت، ما زال حتّى اليوم لا يهدأ. ينتج سنوياً مئات اللوحات، حتى اتهمه بعض النقاد بأن التجارة طغت على أعماله الفنية. تزيّن لوحاته عدداً من المتاحف العالمية، أهمها متحف الفاتيكان. كذلك نُشرت أبرزها مع نبذة عنه في موسوعات فنيّة تشكيليّة في العالم. أما جدارياته وأعماله الإسلامية، فتتوزع على عدد من القصور والقاعات الشرقية في دول الخليج، منها جداريّتان مذهّبتان بقياس خمسة أمتار في مركز دبي العالمي للتجارة... أما معارضه، فقد جالت على عواصم العالم الفنية من بيروت إلى باريس، ونيويورك، ولوس أنجليس، وجنيف، والبندقية، وكوالا لمبور، وألمانيا، والإمارات العربية، والخليج العربي وتونس.
في التسعينيات، طبع اللون الأزرق ومشتقاته أكثر لوحاته، لكنّه لم يتخل عن الحرف. صارت لوحاته مهرجانات من ألوان متوهجة، نورانية، من خيول جامحة تمتزج بحروف وأطياف راقصة وخيالات نسائية ووجوه من عالم آخر. قال عنه صديقه الشاعر هنري زغيب: «ضاق به اللون عن الصراخ. ضاقت به القماشة البيضاء عن المدى، فكسر كل مألوف وقرّر أن يجرؤ: أخذ يرسم بالضوء». وقال عنه أدونيس: «أقرأُ رسوم وجيه نحلة، فيخيل إلي أنه يستخدم جسد الكلام لكي يصلنا بالبدايات».
أمّا وجيه المتربع على مسيرة متراكمة أنجز خلالها نحو سبعة آلاف لوحة، فيقول: "أنا خلقتُ أنا. صنعت أكاديميتي وأسلوبي الخاص. فالفن يحتاج إلى ثماني ساعات من العمل اليومي"، و"لا تستمد ما تريده من المحسوس والملموس، بل من روحانيات هلامية، فضائية، فيها نور وصفاء، بعدٌ وسفر".