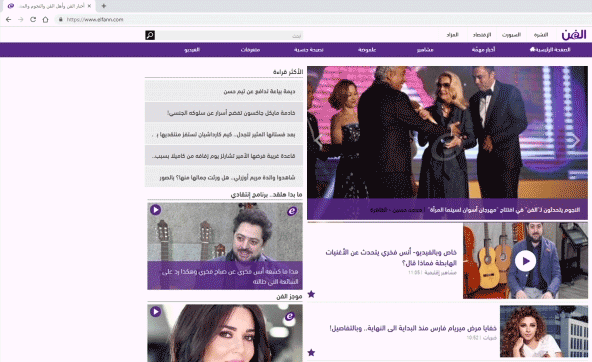ميخائيل نعيمة مفكر لبناني وهو واحد من الجيل الذي قاد النهضة الفكرية والثقافية، وأحدث اليقظة وقاد إلى التجديد، وأفردت له المكتبة العربية مكاناً كبيراً لما كتبه وما كُتب حوله.
فهو شاعر وقاصّ ومسرحيّ وناقد وكاتب مقال ومتأمّل في الحياة والنفس الإنسانية، وقد ترك خلفه آثاراً بالعربية والإنجليزية والروسية؛ وهي كتابات تشهد له بالامتياز وتحفظ له المنزلة السامية في عالم الفكر والأدب.
 ولد نعيمة في بيتٍ فقير، «غرفة مربّعة لا يتجاوز طولها وعرضها السبعة الأمتار، وعلوّها الثلاثة». في هذا البيت الضيّق ولد ودرج، وفيه كان يصلّي مع أمّه من أجل «أبٍ في السماء وأبٍ في أميركا»، ومنه انطلق «محمولاً على كتف أمّه إلى الكنيسة» انطلاقةً تركت في أعماقه أثراً بالغاً. إنّ الأجواء الدينيّة خيّمت على نعيمة منذ نعومة أظفاره، وكان لبسكنتا، بلدته الجميلة، أثرٌ في تربية إحساسه وإذكاء عاطفته وخياله. أمّا وادي الشخروب، حيث سفح صنّين وصخوره ونبعه، فمحطّة من أهمّ محطّات رحلة عمره، «استغلّ منها ما هو أثمن حتّى من العافية ومقوّمات العيش». من الشخروب استمدّ نعيمة الإلهام والإيمان وحبّ الطبيعة، وهناك كان يقضي الساعات متأمّلاً، مغربلاً الماضي، معزّياً النفس، فاتحاً كوى الروح لنور الله.
ولد نعيمة في بيتٍ فقير، «غرفة مربّعة لا يتجاوز طولها وعرضها السبعة الأمتار، وعلوّها الثلاثة». في هذا البيت الضيّق ولد ودرج، وفيه كان يصلّي مع أمّه من أجل «أبٍ في السماء وأبٍ في أميركا»، ومنه انطلق «محمولاً على كتف أمّه إلى الكنيسة» انطلاقةً تركت في أعماقه أثراً بالغاً. إنّ الأجواء الدينيّة خيّمت على نعيمة منذ نعومة أظفاره، وكان لبسكنتا، بلدته الجميلة، أثرٌ في تربية إحساسه وإذكاء عاطفته وخياله. أمّا وادي الشخروب، حيث سفح صنّين وصخوره ونبعه، فمحطّة من أهمّ محطّات رحلة عمره، «استغلّ منها ما هو أثمن حتّى من العافية ومقوّمات العيش». من الشخروب استمدّ نعيمة الإلهام والإيمان وحبّ الطبيعة، وهناك كان يقضي الساعات متأمّلاً، مغربلاً الماضي، معزّياً النفس، فاتحاً كوى الروح لنور الله.

2. الهجرة:
لعلّ الهجرة أكبر ظاهرةٍ لبنانيّة في العالم، حتى لقد قيل: لو تمّ ارتياد القمر لكان في طليعة الواصلين إليه لبنانيّان: الأوّل يحمل «كشّة» على ظهره، والثاني يحمل قلماً ودواة! عانى نعيمة مأساة الهجرة: فأبوه مهاجر وهو نفسه هاجر. ويمكننا فتح أيِّ كتاب من كتب نعيمة لنقع على الهجرة ماثلةً ومعها الحنين إلى الشرق. وكان من أثر الهجرة على المهاجرين أنّها «وسّعت آفاق حياتهم ووضعتهم في قلب الحضارة الحديثة، وعلّمتهم الحنين والتفكير الدائم في الوطن». ومثلَ ذلك قل في نعيمة، وهو المشغول بالشرق وقضاياه، والشغوف بروحانيّته بعد أن فتحت الهجرة عينيه على ماديّة الغرب وحضارته.

3. الروحانيّة:
إنّ طفولة نعيمة الفقيرة البائسة المشبعة بالأجواء الدينيّة المسيحيّة في بقعةٍ من أجمل بقاع لبنان، وإنّ تجربة الهجرة التي خاضها وكشفت له برق المدنيّة الخُلَّب، غذّتا روحه، فإذا هو يعكف على قراءة الكتاب المقدّس والقرآن الكريم ولا يعدل بهما كتاباً. وهذه الروحانيّة الشرقيّة تجلّت في كتاباته تجلّياً قويّاً جعل الباحثة ثريّا مَلْحَس ترى في نعيمة أديباً صوفيّاً من طراز أبي العلاء المعرّي.

4. الثقافة الشرقيّة:
إنّ الروحانيّة الشرقيّة التي أصّلتها طفولة نعيمة وتجربة الهجرة في نفسه، وجدت مداها الطبيعيّ في ثقافته الشرقيّة؛ فهو رجلٌ ألمّ بالفلسفات الهنديّة والصينيّة، وأُعجب أشدّ الاعجاب ببوذا ولاوتسو، واطّلع على التصوّف الإسلاميّ، وأُعجب أيضاً بالحلّاج وابن عربيّ. ولكن أهمّ ما أثّر في نعيمة على الإطلاق المفكّرون الروس. ونكاد لا نعثر على كتابٍ له إلّا ويُشيد فيه بسحر التراث الروسيّ. قال: «إنّ ما يُعرف اليوم بالأدب الواقعيّ بلغ ذروته على أيدي الكتّاب الروس أمثال غوغول وتورغنييف ودوستويفسكي وتولستوي وتشيخوف وغوركي... وهؤلاء فتحوا لي الباب إلى الأدب الإنسانيّ الرحب، فنهجت نهجهم في ما صنّفتُ من قصص. أمّا في النقد فقد وجدتُ في بيلينسكي - إمام النقّاد الروس- مثلاً رائعاً للنقد الرفيع. وأمّا في الشعر فقد أُعجبتُ كثيراً ببوشكين ولرمونـتوف ونكراسوف». تولستوي هو «عملاق الروح والقلم»، وبوشكين «باني الأدب الروسيّ»، وغوركي «ربٌّ من أرباب الكلمة المجنّحة». لقد أحبّ نعيمة روسيا والشعب الروسيّ وتحسّس آلام طبقة الفلاّحين والعمّال، وكان يشعر في أعماق نفسه بأنّ مُهمّة الأدب هي كفاح الواقع المرير وإعداد المستقبل الزاهر، وتوجيه البشر إلى ما فيه سعادتهم. زد على ذلك أنّ السنوات الخمس التي قضاها طالباً في روسيا لم تُشبع روحه بالروح الثوريّة، بل بالروح المستسلمة الوادعة.

5. الثقافة الغربيّة:
لم يفصم نعيمة عَلاقته بالثقافة الغربيّة، فقد كان يرى أنّ سعادة البشر لا تكتمل إلّا إذا اتّحد الشرق والغرب وعادا، كما كانا، توأمين. أي إنّ سعادة الإنسان لا تتمّ إلّا بتهذيب قلبه وتهذيب عقله، أو إذا حقّق المساواة بين دينه وعلمه، وبين الروحانيّات والماديّات. وإذا كان للأديب ثمّة رسالة فليست أقلّ من «أن يبني الإنسانَ بناءً لا تزعزعه عواصف الساعة». من هنا راح نعيمة يعبّ من الثقافة الغربيّة قارئاً أفلاطون وسبينوزا ولايبنتز وبرغسون، ومعجباً بوولت ويتمن «أبي الشعر المنسرح»، ومتحمّساً لرالف أمرسون «حكيم كنكورد»...

6. جبران خليل جبران:
لا عجب إن تأثّر نعيمة بزميله وصديقه جبران، فهما من طينةٍ واحدة: كلاهما عانى الفقر في طفولته وذاق مرّ الهجرة، وكلاهما اطّلع على آداب الغرب وهام ب الكتاب المقدّس، وكان لهما من نفاذ الحسّ وثاقب البصيرة ما جعلهما يشعران بقصور الأدب العربيّ عن مواكبة الحياة، فعقدا العزم على انتشاله من كبوته وتألّفت الرابطة القلميّة من أجل هذا الهدف. لقد كان نعيمة يرى في جبران الأديبَ الحقّ الذي صفت روحه للحقّ، وكان يشعر بأنّ آلام جبران وأفراحه ترسب في أعماقه، وتمتزج برواسب أفراحه وآلامه. ولذلك كان لا بدّ من أن يتأثّر نعيمة في فكره وأدبه ونقده برئيس الرابطة القلميّة وعميدها: لقد كتب زاد المعاد (1936) ومِرْداد (1952) على غرار ما كتب جبران النبيّ (1923)، وكتب كَرْم على درب (1945) على غرار ما كتب جبران رَمْل وزَبَد (1926). وفي الغربال (1923) يجعل نعيمة جبران مثلَ الأديب الأعلى، العواصفَ (1920) عواصفَ حقيقيّة تطيح بحياتنا الأدبيّة الرثّة وتذهب بأفكارنا المنتنة.

هذه المؤثّرات التي عملت على تشكيل نعيمة فكريّاً وروحيّاً تركت بصماتِها على أدبه ونقده، فكان ذا مفهومٍ في الفنّ والأدب واضحٍ معلوم، ما حدا الباحث محمّد شفيق شيّا على إدخال الفنّ والجماليّات في فكر نعيمة كأساس من الأسس التي تقوم عليها فلسفته.
قال في الفنّ: «إنّ أجمل الفنّ ليس في المتاحف ومحترفات الفنّانين بل في حياةٍ موحّدة الغاية والإرادة، في قلبها إيمان لا يتزعزع بهدف الإنسان الأسمى، وفي إيمانها محبّة لا تنضب لكلّ من شاركها وما شاركها ذلك الهدف».
وقال في الأدب: «أريده أن يعطي الإنسان إيماناً بأنّه معدّ لتاج الألوهة... أمّا الأدب الذي لا يرمي إلى أبعد من رصف الكلام الجميل والإيقاع الموسيقيّ وإثارة الغرائز البشريّة وتسلية الأفكار، فهو في نظري رغوة وإن بدا في حلّة من الجمال والاغراء».
وقال في النقد: «الغربلة سنّة من السنن التي تقوم بها الطبيعة وسنّة البشر الذين هم بعضٌ من الطبيعة».
وقال في النقد والناقد كليهما: «النقد مُهمّة شاقّة إلّا على الذين وهبتهم الطبيعة حسّاً مرهفاً بالجمال. والكلمة وحدَها التي هي أداة الأدب الأولى تستطيع أن تجمع بين جميع الفنون من هندسة وتصوير وموسيقى وحركة... فالناقد الذي لا يحسّ جميع هذه الجوانب العميقة في الكلمة لا يستطيع أن يكون ناقداً. والنقد لا قيمة له إلّا إذا كان خَلْقاً... ولا بدّ للناقد من ثقافةٍ واسعة جدّاً ومن ذوق مرهف وخيال وثّاب وفكر نفّاذ ومقدرة على التعليل».
الفنّ إذن، بما فيه الأدب، هادفٌ إلى مساعدة الإنسان على اكتشاف ذاته واكتشاف الله في ذاته بالمعرفة والحريّة. الأدب رسالة الحياة ورسولها في آن: رسالة الفضائل الإنسانيّة ورسول الخير والحقّ والجمال. والنقد، مهمّته أن يساعد الأدب، فيبيّن الغثّ من السمين، والزائف من الصحيح، ويكون مُسهماً في كشف الحقيقة: حقيقة الإنسان ذاته وحقيقة الله، وهما في آخر المطاف يتوحّدان.
تُشبه نظريّةُ نعيمة في الفنّ نظريّةَ تولستوي؛ غاية الفنون يجب أن تكون نبيلة، وهي ترقية شأن البشر، وراحة النوع الإنسانيّ، والمساعدة على رفع راية السلام في العالم أجمع.
أفرد نعيمة للنقد الأدبيّ كتابَيْن: الغربال (1923)، وفي الغربال الجديد (1972). بيد أنّنا نجد له مقالاتٍ نقدّية عديدة موزّعة في كتبه الكثيرة.
أمّا الغربال فعليه قامت شهرة نعيمة في النقد الأدبيّ، وبه استهلّ حياته الأدبيّة، وإذا كان أحبّ الكتب إلى عبّاس محمود العقّاد كتابه ابن الروميّ، حياته من شعره، فإنّ كتاب الغربال هو الأحبّ إلى قلب نعيمة. قال: «كتاب الغربال لا يزال عزيزاً عليّ لأنّه الكتاب الذي شققتُ به طريقي في دنيا الأدب». حمل هذا الكتاب ثورة الرابطة القلميّة على الأدب القديم وغدا بسرعة «دستوراً أدبيّاً لم يألفه الشرقيّون». وقد ضمّ بين دفّتيه اثنين وعشرين مقالاً: مقالين ضدّ الأدب العربيّ التقليديّ والتحجّر اللغويّ، ومقالاً واحداً ضدّ العَروض التقليديّ، وثلاثة عشر مقالاً في النقد التطبيقيّ، وستّة مقالات في النقد البنّاء.
وأمّا في الغربال الجديد فكتاب يتضمّن آراء نعيمة في روائع الأدب العالميّ وفي آثار العديد من أدبائنا ومفكّرينا المعاصرين. وهو إن دلّ على شيء فعلى سعة الثقافة النعيميّة وعمقها، وعلى رعاية النعيميّ الجيلَ الجديد من الأدباء والأديبات.